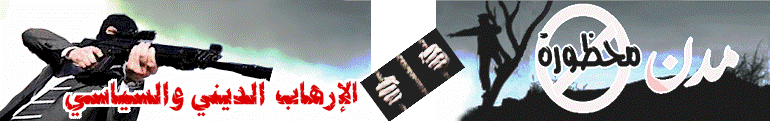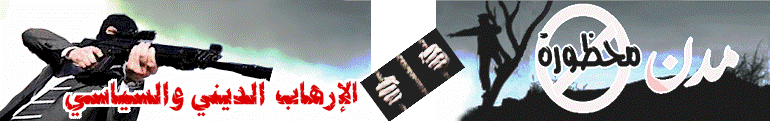|
عيش المجتمعات الإسلامية واقعاً يتسم بانعدام الديمقراطية، بل هي أقل
المجتمعات تمتعاً بالديمقراطية بين أقرانها من مجتمعات العالم المعاصر.
لن نخوض اليوم في إمكانية التوفيق مستقبلاً بين الإسلام والديمقراطية، بل
غرضنا تسليط الضوء على طبيعة العلاقة القائمة حالياً بين الإسلام كتيار
سياسي وبين الديمقراطية كمنظومة دولية عالمية .فالإسلام
الحالي لا يمكن فصله عن التيارات السياسية التي تدعي انتماءها له، لأنه
يعرف عن ذاته كعقيدة دين ودنيا، فيجاوز في بعده دستور الحياة لكل مسلم
إلى تنظيم سياسي يقوم على تأمين العدل والمساواة بين البشر
.
وبما أنه يقيم ذاته كذلك، فهو يدعي أنه الأصلح لإدارة المجتمع البشري من
الديمقراطية الكافرة التي خرجت من رحم الإنسان العبد ضعيف الرؤيا ومحدود
الفكر، والتي لا تقارن بالرؤيا الإلهية التي منحها الله للمسلمين في
كتابه العزيز، وفي المقابل فإن الديمقراطية الغربية تبادل الإسلام هذه
النظرة الدونية التي يصمها بها، فهي ترى في الإسلام السياسي أحد أكثر
الأنظمة السياسية تخلفاً وبدائية.
إن تشخيص العلاقة الراهنة بين إسقاطات هذين المنهجين هو أمر ضروري قبل
محاولة استكشاف إمكانية وجود تلاقي أو تنافر بينهما، فالعلاقة الحالية
الراهنة بين الإسلام كتيار سياسي والديمقراطية كمنظومة دولية هي علاقة
صدمة هائلة بين كائنين ارتبطا يوماً ما بعلاقة غير شرعية
.
إن هذه العلاقة غير الشرعية دامت لأكثر من خمسين عاماً ثم أصابها التفكك
ككل علاقة انتهازية قامت على استغلال الآخر لأغراض آنية مرحلية، وعقب هذا
التفكك بدأت المواجهة وغدا كل طرف محبط من الآخر بعد أن أحاطت به آثار
الصدمة .
ورغم أن كل منهما مصدوم بالآخر، إلا أنهما وخلال تعاون طويل قد حاولا
تجنب هذه الصدمة أو تأجيلها ولكن ما كان بالإمكان في نهاية المطاف إلا
حدوثها، وبالشكل الذي نشهده اليوم، فالمنهجان، الديمقراطي والإسلامي
يختلفان في كل شيء من حيث المنشأ والتطور والآلية المحركة لكل منهما،
فالإسلام السياسي هو تسليم بسلطة شريعة عمرها 1400 سنة، ومحملة بميراث
ثقيل من التقليدية والأصولية والفقه السلفي والتفسيرات والتأويلات
والأحكام والفتاوى وما إلى آخر القائمة من أدبيات وتشريعات.
أما الديمقراطية الغربية فهي آلية لإدارة مجتمع حديث متغير باستمرار يضع
حقوق الإنسان الفرد في المقدمة وفوق أي شريعة دينية
.
وكان أن وقعت ((غزوة)) 11 سبتمبر التي فتحت باب المواجهة من أوسع الأبواب
والتي اعتبرت النتيجة المنطقية لهذا الخلاف في المنهج فهذا الزرع سوف
يؤتي يتلك الثمار .
وجاء الصدام المتوقع على توزيع الغنائم ، لكن لا بد من الإشارة هنا أن
الديمقراطيات الغربية حاولت كدول ومنظومات فكرية تجنب الصدمة الوجاهية
بالإسلام السياسي رغم معرفتها المسبقة، بحكم تقدم وسائلها المعرفية
ومناهجها البحثية، بأن التناقض هو ذو طبيعة جوهرية بين الديمقراطية
والإسلام، على الأقل بشكله الحالي وهذه الرغبة التكتيكية بتجنب الصدمة
كان مردها انشغال الديمقراطيات الغربية بصراعها الاستراتيجي مع الدول
الشيوعية والمنظومة الشمولية ، وفي خضم هذا الصراع المستميت، وجدت
الديمقراطيات الغربية في الإسلام السياسي حليفاً شديد الحماس لمؤازرتها
ومعاداة الفكر الشيوعي الإلحادي وهكذا لم تبخل المخابرات الغربية في
استعمال الإسلام السياسي كحليف جهادي ضد الشيوعية
.
وهذا ما تجلى في تبنيها للأنظمة السياسية الأصولية في العالم العربي
والعالم الإسلامي كالنظام السعودي وسواه كما واستضافة العواصم الأوربية
لزعماء التيار الإسلامي المطاردون من حكومات دولهم العربية الإسلامية
وتعاملها معهم كزعماء للمعارضة السياسية لا كمجرمين صدرت بحقهم أحكام
قضائية ، فكان دعمها للتنظيمات الأصولية كما حصل في أفغانستان، حيث تطوع
الإسلاميون من كل حدب وصوب لمحاربة الشيوعية تحت غطاء الرعاية
الاستراتيجية الأمريكية، لقد أثلج الإسلاميون صدر أميركا لأنهم كانوا أشد
عداءً منها للشيوعية وأكثر اندفاعاً، فأخذت أميركا تمدهم بالدعم والتسليح
وكل أشكال المساعدة، فالغرب عموماً استعمل تيار الإسلام السياسي كأداة
قاتلة سرعت في انهيار الكتلة الشرقية، وشعر أتباع هذا التيار بزهو
الانتصار كونهم سددوا ضربة قاضية للفكر الإلحادي وساهموا في نصرة دين
الحق .
ومن ناحية أخرى، كان الإسلام السياسي الحليف الطبيعي للديمقراطيات
الغربية التي كانت، ومن منظور نفعي إمبريالي ، راغبة في خنق المشروع
القومي العربي الوحدوي، بغرض استمرار هيمنتها، وسيطرتها على المنطقة
العربية وثرواتها النفطية ، وقد نجح الإسلام السياسي، بانتهازيته
المعروفة وشهوته الهائلة للسلطة، للمساهمة في محاربة الفكر القومي
بالتعاون مع الدوائر الاستخباراتية الغربية لإفشال المشروع القومي
الوحدوي، دون إغفال منا لحقيقة هامة هي أن الفشل كان مرده لعيوب داخلية
وأهمها إهماله للبعد الديمقراطي وتفضيله للتوجهات الشمولية عموماً
والطائفية أحياناً والاستبدادية دائماً في كل صيغة حاول تنفيذها، لكن هذه
العيوب، على فظاعتها لا تستر الأعمال الهدامة التي تطوع بها التيار
الإسلامي ممثلاً بالدول التي ترعاه كالمملكة العربية السعودية، وبالأحزاب
والجماعات المناصرة لها، كالإخوان المسلمين وجميع الأحزاب الإسلامية التي
خرجت من تحت مظلتهم إضافة إلى الفكر القدري المتسلل مع اسثمار نفطي في
الدول العربية .
لقد ساهم كل هؤلاء بإيجابية منقطعة النظير في التعاطي مع عروض سخية من
المخابرات الغربية بكل أشكال التحالف والتآمر لإسقاط كل رموز التيار
القومي من دول وأنظمة وأحزاب ومفكرين .
لقد شكلت المصلحة المشتركة لمحاربة عدو واحد محركاً لهذا التحالف الغير
مقدس والذي ساهم مع العدوان الإسرائيلي عام 1967 في تهديم المشروع القومي
والوحدوي والذي أصبحت الدول العربية من بعده في مرحلة من التخبط الأعمى
بين نموذجين كلاهما عقيم
.
النموذج الأول هو الدكتاتوريات العشائرية القبلية الطائفية وأسوأ نماذجها
كان نظام صدام حسين، والنموذج الثاني هو الأصوليات الإسلامية كسلطات
قائمة أو كتنظيمات ساعية للسلطة بدءاً من وهابية آل سعود ووهابية
معارضيهم، مروراً بإخونجية مصر وسوريا وجزاري الجزائر وغيرهم في السودان
والمغرب وتونس والكويت والقائمة تطول .
حيت كانت أغلبية أطياف الإسلام السياسي بشكل مباشر أو غير مباشر، منخرطة
في هذا التحالف مع وجود استثناءات قليلة تتمثل خصوصاً في الأصولية
الشيعية (( إيران وحزب الله )) وبعض المنظمات الإسلامية الفلسطينية
.
إن التحالفات الانتهازية والظرفية التي قامت بين معظم أطياف التيار
الإسلامي السياسي وحكومات الديمقراطيات الغربية ومخابراتها هي حقيقة لا
بد من تثبيتها قبل المضي قدماً في التحليل لأن طرفي هذا التحالف، وبنفاق
ما بعده نفاق، حاولا التستر في أدبياتهم عن هذا التحالف وإنجازاته
.
فالتيارات الإسلامية السياسية، التي حاربت وبشراسة منقطعة النظير كل
المشاريع التنويرية العربية، كانت تتمتع دائماً بمراكز لتنسيق نشاطها
وتمويلها في قلب العواصم الغربية وخاصة لندن، وهذه التيارات تتستر الآن
برداء فضيلة غير موجودة وتتنكر صباح مساء لتعاملها السابق الطويل
وارتمائها في أحضان المخابرات الغربية، وإننا نرى في المقابل نفس الموقف
لدى معظم الدوائر الغربية التي تدعي أنها فوجئت بالفكر السياسي الإسلامي
ومدى العنف والإرهاب القادر على ارتكابه، متناسية بدورها تاريخاً كاملاً
من التعاون المشترك والمثمر بينهما، من رعاية وحماية لأنظمة أصولية
وتدريبات لجماعات مسلحة ورعاية لقاعدة عريضة من التنظيمات الإسلامية،
والحقيقة الوحيدة هي أن الدوائر الغربية لم تفاجأ بعنف الإسلام السياسي،
وإنما فوجئت الآن بارتداده عليها.
والسؤال الذي سنطرحه الآن: كيف انتقل هذان الطرفان من التحالف الودود إلى
الصدام اللدود؟
للإجابة على هذا السؤال سنتحدث بداية عن فترة تراخي هذا التحالف وصولاً
بعد ذلك إلى لحظة الصدمة في 11 سبتمبر.
إن هذا التحالف الانتهازي قد وقع ضحية نجاحه المنقطع النظير فلقد نجح هذا
التحالف في إفراغ السلطة العربية ممن أراد الطرفان إسقاطه فالتيارات
الاشتراكية والشيوعية سقطت .. والتيارات القومية خف بريقها تحت الضربات
المشتركة من التيار الإسلامي والعداء الأمريكي والعدوان الإسرائيلي،
وفرغت الساحة العربية من أي تيار فكري شعبي تنويري وبدا أغلب المفكرين
العرب التنويريين كطيور تغرد خارج السرب يعانون الاضطهاد والتهميش
.
وقد أفاد هذا التيار من التغطية الأميركية والأوروبية له ليحارب كافة
الأفكار الليبرالية والتنويرية في المجتمعات العربية مستغلاً إحباط ويأس
الشعوب العربية من فساد حكامها وعجزهم عن مكافحة الفقر والتخلف وعجزهم عن
إيقاف العدوان الإسرائيلي ، ومن محاربة رموز التيارات السياسية الوطنية
بنفيهم أو سجنهم أو قتلهم قد أصابوا المجتمعات التي تربعوا على عرشها
بحالة أشبه بالغيبوبة الدائمة أو الوفاة السريرية، ومنذ ذلك الحين بدت
الساحة السياسية خاوية من قوى حقيقية فاعلة ومحركة، ولم يبق في الميدان،
كديناميكية حقيقية، سوى طرفي هذا التحالف الذي بدأ يصيبه التراخي بسبب
انعدام وجود أعداء حقيقيين ألداء يستحقون أن تحاك لهم المؤامرات كما في
السابق، وصارت المنطقة العربية مفرغة إلا من قطبين هما القطب الإسلامي
والقطب الأمريكي ..
ورغم خروج أميركا منتصرة من الحرب الباردة ورغم ترويجها لنظام عالمي جديد
قائم على احترام حقوق الإنسان إلا أنها غضت الطرف تماماً عن الأنظمة
العربية الاستبدادية أو الأصولية وتابعت رعايتها لها طالما أنها بقيت تلك
تابعة وطيعة ، وهكذا لم تغير أمريكا من استراتيجيتها كما لم ينعم أي
مشروع عربي ديمقراطي أو تنويري بمناصرتها ، ومن جهة أخرى، كانت القوة
الأخرى الموجودة تتمثل في التيار الإسلامي السياسي، القوي بغوغائيته
وطروحاته المسطحة والمخدرة لعقول الجماهير العربية المحبطة، والذي أصبح ،
وبسبب الغيبوبة الفكرية النقدية العربية لاعب الساحة الرئيسي يسرح ويمرح
بكامل حريته متجهاً في طروحاته المتواترة نحو مزيد من التطرف والعنف
والإرهاب الفكري وتغييب العقل والفكر النقدي
.
وهكذا، صار هذا التيار رغم تهوره، وتخلفه وقصوره المعرفي، شديد الحركة
والفاعلية، في ساحة شبه خاوية، لضرب بقايا أي فكر تنويري نقدي قد ينافسه
أو يكشف نواقصه وعيوبه فضاعت في عالمنا العربي
فرصة فريدة للتقدم نحو الديمقراطية أفادت منها غالبية مجتمعات العالم في
فترة التسعينات، بينما بقيت مجتمعاتنا تلوك قيم وثوابت كانت قد ارتدت
عليها بعد فترة من النهضة الفكرية العربية والتي قامت على مفكرين عرب
عظماء أدركوا فشل الفكر الديني السياسي الذي استمر في بلادهم لعقود طوال
مخدراً شعوب المنطقة وسالباً إياهم أي قدرة على الحراك باتجاه تطور وتقدم
مواطنيهم .
لقد اعتقدت أغلب المجتمعات العربية في فترة الخمسينات من القرن المنصرم
أنها قد غادرت الفكر السلفي والقدري إلى غير رجعة لكن الثمانينات
والتسعينات شكلت ردة قوية تجاهه لذلك فشل المثقف العربي لغياب أي دعم
حكومي أو خارجي أو حتى شعبي من مواكبة المجتمعات العالمية الساعية نحو
منح الانسان حقوقه كما شرعت لها الجمعيات العالمية لحقوق الانسان ما أدى
إلى تردي أوضاع المجتمعات العربية والإسلامية وإحباطها في مواجهة أي تقدم
يذكر .
وبعد غياب القطب الآخر ، وفشل الفكر الشمولي تمكنت الهيمنة الأميركية
الأمبريالية من الاستئثار بمقدرات لم تكن متاحة من قبل، وكان لا بد من
أيديولوجيا جديدة فادعت الدفاع عن الحريات في مواجهة القمع والدكتاتوريات
المتبقية في العالم ، والتي ترزح جاثمة في عالمنا العربي، لكن بقيت هذه
البروباغاندا الإعلامية أقرب إلى الشعارات والكلام المعسول لأنها وعلى
أرض الواقع لم تكن لتهتم بنشر الديمقراطية بل كما لم تبد أي حماس لتطبيق
أي من مبادئها في عالمنا العربي.
ومن ناحية أخرى مضت التيارات الإسلامية في بنيان مشروعها التهديمي لكل ما
هو تنويري من خلال الإرهاب الفكري والتكفير والقتل نافثين بآدابهم
وإعلامهم المدعوم نفطياً إلى ترويج عقيدة جامدة متخلفة، والتي لا تريد
للإسلام إلا أن يكون سداً منيعاً تجاه الحداثة فلا يحاورها ولا يتلاقى مع
قيمها التي تدعو إلى حراك ديمقراطي اجتماعي وخروج الشعوب العربية من حالة
السبات والتلقي لتكون فاعلة بدور أسوة بغيرها من المجتمعات المعاصرة
.
وهكذا، وبوجود قوتين فاعلتين تملكان طموحات واسعة في ساحة أفرغها
الاستبداد والإفناء لفعاليات المجتمع المدني ,كان التموضع والتمركز
لهاتين القوتين مقدمة لاصطدامهما للإنفراد بالسيطرة على الساحة.
لقد بدا أن التحالف الانتهازي القديم بينهما فقد مبرراته بانعدام أي سبب
فعلي يستدعي تواجده ففي غياب أي عدو مشترك لهما، افترقت المصالح وذهب كل
منهما باتجاه آخر مغاير بعد أن بات لكل من الطرفين طموحاته الواسعة
ومشروعه الخاص وأجندته التي تتعارض مع الآخر
.
وفي سياق العنف الذي كان الإسلاميون يمارسونه ويصعدونه من بلد عربي لآخر
في معارك هدفها استلام السلطة، وجد من بين هؤلاء الإسلاميين من ارتأى
أخيراً تصدير العنف إلى ملعب حليف الأمس – أميركا
.
فهذا الحليف – أميركا – قد ارتكب بعد حرب الكويت خطأ لا يغتفر لا بل أقدم
على ارتكاب خرق لمحرمات الإسلام السياسي بإقامته وجوداً عسكرياً أمريكياً
دائماً في الجزيرة العربية التي يراها هؤلاء قدس أقداسهم فدنسوها بنسائهم
وعاداتهم وعتادهم، مما حدا بخروج الجناح المتطرف من صفوف الإسلاميين
داعياً وبجهارة وجرأة تصل لحد التهور إلى فتح النار على حليف الأمس،
وبشكل هوليودي يترك بصمة تاريخية لا تنسى، فكانت (( غزوة نيويورك وواشنطن
)) التي أرادوها بداية لغزوات أخرى فإذا بها تفتح على العرب باب جهنم،
باب الغزوات الأمريكية المعاكسة والتي اتضح بأنها أشد فاعلية وأكثر
ديمومة، فكانت صدمة الحادي عشر من سبتمبر، والتي خرج علينا في أعقابها،
الطرفان إياهما، الإسلامي والأمريكي، بنظرتهما الجديدة الواحد تجاه الآخر.
فالأمريكيون لم يكتشفوا فجأة ما كانوا يعرفونه تماماً، وهو أن الإسلاميين
هم أبعد البشر عن الديمقراطية وحقيقة الأمر هي أن مفاجأة الأمريكيين لا
تكمن في عجز الإسلاميين لتقبل الفكر الديمقراطي، فهذا ما يعرفونه بداهة
إنما المفاجأة الحقيقية لأميركا، وللغرب عموماً، كانت في قدرة الإسلاميين
على الحقد على الغرب وإيذائه بهذا القدر الشديد من العنف، وهكذا اصطنع
الغربيون مفاجأتهم ودهشتم تجاه تصاعد هذا الوباء الخطير الذي ساهموا في
إذكائه ونشره ليصيب الآخرين فإذا به يرتد عليهم ويصبح قادراً على إيلامهم
وبقسوة .
وهكذا، وعلى قدر كبير من النفاق يكرر الأمريكيون على مسامع الناس السذج
بأنهم استيقظوا غداة الحادي من سبتمبر مفاجئين بظهور الإرهاب الإسلامي
الأصولي الذي ضربهم عنوة و بقوة .
مغمضين العين عن آلاف الملفات المخابراتية التي تمتلئ بها خزائن مكاتب
مخابراتهم و الكفيلة بإعطاء العالم أجمع الصورة الواضحة عن التعاون
والرعاية التي توليها هذه الأجهزة لمنابر الفكر الإسلامي السياسي بدوله
وأنظمته وتنظيماته المسلحة وغير المسلحة.
أما الإسلاميون في المقابل، وبنفاق لا يوازيه سوى النفاق الأمريكي، أخذوا
يوضحون لكل مغفل بأنهم وعلى الدوام كانوا أشد أعداء السياسة الأمريكية
متنكرين تماماً لتاريخ عريق من التحالف والعلاقات الحميمة، إن هذا
البراءة المصطنعة للطرفين لا يجوز أن تغيب عن ذهن من لديه ذرة من الذاكرة
أو المنطق، فالطرفان الأمريكي والإسلامي، يستحقان على هذا الأداء الجائزة
الأولى للنفاق العالمي، إن هذه البراءة المزدوجة المزعومة قد وجدت فقط
للتمويه ولغرض التسويق الداخلي لجماهير طرفي النفاق العالمي
.
والسؤال التالي : ماذا بعد الصدمة ؟ ماذا بعد صدمة هذين الكائنين شديدي
الشراسة والذين ارتبطا يوماً ما بعلاقة غير شرعية وحلف غير مقدس حتى
تاريخ وقوع القطيعة بينهما ليصبحا على هذه الدرجة من العداوة ؟
إن الغرب، وأمريكا تحديداً، قد أفاقت على إحساس جديد بخطر من حليف قديم
قادر على الإيذاء في عقر الدار وبشكل مباغت غبر تقليدي، وبأسلوب شديد
العنف والقسوة، كل هذا أشعر هذا المارد بالإهانة .. فبدا كعملاق جريح وقد
حدد أولياته التي تتمحور بالثأر أولاً والوقاية من هجمات أخرى ثانياً ،
ثم السعي لتغيير المنطقة العربية بحيث لا تعود تشكل مصدراً لمثل هذه
التهديدات مستقبلاً وذلك بتفكيك كياناتها أكثر وغزو بعض أقطارها وعزلها
عن جوارها وإلغاء أي رابط عربي أو إسلامي بين شعوبها، وبالفعل فقد أعلنت
أمريكا الحرب على الإرهاب الإسلامي واعتبرت أن من ليس معها فهو ضدها في
الحرب على الإسلاميين الذين هم بادلوها نفس الدرجة من العداء
.
و انفرز المعسكران بعد انفراط عقد الود السابق بينهما وصار كل يوم يحمل
حرجاً شديداً للزعماء والقادة الرسميين من زعمار التيار الديني السلفي ،
بعد أن وقعوا فريسة ضغط هائل من المارد الهائل الجريح الذي طالبهم
باستحقاقات لا جدال فيها، تجلت في تغيير خطابهم الاسلامي المتطرف إلى آخر
معتدل و تعديل المناهج الدراسية التي عملوا على تطويرها طوال خمسين سنة
لاجتثاث الرؤية العنصرية تجاه الآخر المختلف، والتي خرجت وبجدارة منابر
التيار الإسلام السياسي، وإلى وقف الدعم المادي عنهم وتجفيف مصادر
تمويلهم .
فهم إن أقدموا على الرضوخ التام للمطالب الأميركية فسيجعلهم أمام
مجتمعاتهم المسيسة إسلامياً ينقذون عكس خطاباتهم الديماغوجية السابقة،
مما يعرضهم للمواجهة مع نمور ربوها في حظائرهم لمدة طويلة لتكشر عن
أنيابها لتنقلب فجأة ضدهم فتفتك بميراثهم مهددة وجودهم
.
وهكذا لم تترك هذه الأوامر القاسية، لهؤلاء القادة أي مساحة للمناورة وهم
إن لم يذعنوا تعرضوا إلى ما تعرض إليه العراق وزعيمه المخلوع، في رسالة
واضحة أوصلتها لهم الإدارة الأميركية بكل وقاحة وحزم
.
وكان لا بد لهم من مواجهة استحقاقات داخلية بأن يقوموا بخلع الشوك الذي
زرعوه بأيديهم .
في المقابل لم يسلم التيار الإسلامي بل مضى في نزاله معتمداً أسلوبه في
المباغتة والقتل والتفجير وهو أسلوب أشبه بحرب العصابات المكلف، وقام
باستهداف مصالح أميركية وغربية ليقنع أتباعه بأنه قادر على النزال،
والإيلام وأن النصر مكتوب له في النهاية، بل أنه استهدف في بعض الأحيان
الكثير من المصالح الوطنية التي تعود للشعوب العربية والإسلامية في تخبط
يصل لحد الهذيان .
وسرعان ما خرجت صيحات من زعماء التيار الإسلامي تكفر زعماءهم ممن أغدقوا
عليهم ورعوهم حتى الأمس القريب وطالبت بخلعهم لا بل بالاقتصاص منهم
وقتلهم لأنهم تجاسروا وأذعنوا للكفرة من الغربيين
.
وهكذا تحقق للطرف الأميركي وجود عدو شرس وحاقد على مفردات الحضارة
المعاصرة التي ساهم في بنيانها وترويجها وخلق له ذريعة توهم الدول الأخرى
بأهمية محاربة هذا التيار وكافة رموزه وتستدعي وجود جيوش جرارة وميزانية
ضخمة تصرف على التسليح لتقوم بالتدخل في أي دولة تعارض المصالح الأميركية
بحجة محاربة الإرهاب، وكان لا بد من تقسيم آخر للمنظومة العالمية بين دول
صديقة ودول مارقة .
لقد بات الضغط الأميركي المتواصل يضع جميع الأنظمة العربية في خانة لا
يحسدون عليها، والأنكى من ذلك أن استراتيجيتها الجديدة ليست متكاملة، فهي
بعد أن قررت تصفية الوحش الأصولي الذي سبق ورعته فتطاول عليها، لا تبدو
جادة أبداً في وضع التغيير الديمقراطي كهدف مباشر فحسابات مراكز الضغط
تدفع القرار الأمريكي في اتجاهات أخرى .. إذ لا مصلحة لها بأنظمة
ديمقراطية تضع الثروة النفطية في خدمة النمو العربي، ولا مصلحة بأوضاع
ديموقراطية تؤدي إلى لملمة الوضع العربي المفكك والمرغوب باستمراره
إسرائيلياً، ولا مصلحة بديمقراطية عربية تضع الصراع العربي – الإسرائيلي
من جديد في واجهة العلاقات مع أمريكا .
إن اللوبي النفطي ( ضمن استراتيجية الإمبراطورية العالمية )) مثله مثل
اللوبي الصهيوني (( ضمن استراتيجية الهيمنة الإسرائيلية
)) .
لا يريدان للشعوب العربية أن تأخذ مصيرها بيدها وهكذا فإن العملاق
الأمريكي الهائج يتم توجيهه عن بعد بواسطة اللوبي النفطي من جهة واللوبي
الصهيوني من جهة أخرى ليخدم مصالح إسرائيل قبل مصالح العرب وحتى قبل
مصالح أمريكا (حيث المصلحتان متطابقتان وأمريكا لا يمكن لها أن تضحي
بمصالحها.
وأحد الأمثلة هو ما رأيناه من تغطية أمريكية إعلامية وضمن أروقة المحافل
الدولية للاجتياح الإسرائيلي للمدن الفلسطينية مع كل جرائم الحرب التي
ترافقه وهذا هو ما يمكن أن نصنفه من ضمن ((إنجازات )) بن لادن والإسلام
السياسي العنفي الذي وفر الفرصة الذهبية النادرة لإسرائيل لتقوم بما لم
تحلم بتمريره بهذه السهولة قبل 11 سبتمبر، لقد وفرت غزوة سبتمبر
((المباركة )) جواً أمريكياً معادياً لكل ما هو عربي في خلط غير نزيه بين
مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب الإسلامي العالمي وهكذا فإن رد
الفعل الأمريكي قد تم توجيهه من قبل اللوبي الصهيوني وأضيف إليه في العام
الماضي وبتأثير من اللوبي النفطي غزو العراق الذي لم يكن له علاقة
بالإرهاب الإسلامي .
وإنما كان الأمر يتعلق بوضع اليد على منابع النفط واستثمارها حتى الرمق
الأخير حارمة دولة كالعراق أو أي دولة عربية متجاسرة من أي ورقة ضغط يمكن
أن تهدد مصالحها أو مصالح ربيبتها إسرائيل . مع إدراكنا بأن الضغط العربي
بواسطة النفط قد سقط منذ زمن بعيد .
وهذا الغزو أيضاً يمكن أن يضاف إلى ((إنجازات بن لادن والإسلاميين الذين
وفروا اللوبي النفطي الأمريكي فرصة لم يكن لها أن ترى النور لتمرير الغزو
بهذه السهولة لولا (( غزوة )) 11 سبتمبر.
أما من جهة الإسلاميين، فصدمتهم لتداعيات الحادي عشر من سبتمبر من رد فعل
أمريكي كانت صدمة أخرى أشد وطأة وأكثر ذهولاً، فلقد توقع هؤلاء،
وانطلاقاً من أدبياتهم الغوغائية الحماسية الفارغة التي تتعامى عن أسباب
القوة الحقيقية، أن تحالف نظام الطالبان والقاعدة سوف يصمد .. وإذا بنظام
الطالبان ينهار بشكل سريع وكرتوني مثير للهزل والسخرية .. وإذا ببن لادن
يهرب طريداً للنجاة بروحه لاجئاً للإختفاء في الكهوف بعد أن حث زملاءه في
الجهاد إلى موت مجاني سخيف لم يفد أحداً ولم ينفع قضية فالهزيمة، وبالرغم
من كل عنتريات الطالبان والقاعدة ومن تعاطف معهم على طول التيار الإسلامي
وعرضه، كانت هزيمة سهلة وسريعة وتظهر عمق الفجوة بين دولة ديمقراطية
حديثة وبين إمارة المؤمنين المثالية الإسلامية
.
وبعد أن أصابت الصدمة الطالبان وبن لادن، امتدت أمواجها لتصيب كل من
تعاطف معهم في بوتقة الاحتقان الغوغائي الهائل المعتاد على الساحات
العربية والإسلامية، وصدم كل الإسلاميين ليصحوا على واقع مر من أن كافة
منظوماتهم المسلحة هي نمور من ورق أعجز عن أبسط أشكال الصمود وبأن
تعويلهم على الخطابات النارية الحماسية الدينية لدفع الجماهير للثورة
والعنف ليس في محله/ واكتشفوا بأنهم قد وقعوا ضحية غوغائيتهم التي أعمتهم
هم أنفسهم بعد أن أعمت غيرهم، وهم الآن يصحون على الكارثة، فقواعدهم
الأفغانية قد دكت وأمريكا تضيق عليهم وهم ملاحقون في كل مكان يريدون أن
يقيموا فيه وجوداً مسلحاً والمنطقة تقترب أكثر فأكثر من عودة عصر
الاستعمار المباشر، فالعراق محتل ومهدد بالتقسيم والدول المجاورة مستباحة
في أي لحظة، والدول العربية صارت تتبارى في الهرولة لتقديم فروض الطاعة
لأمريكا درءاً لشرها ولغضبها وبعض هذه الدول، ذات الخطاب الإسلامي
الديماغوجي، أصبحت واقعة بين المطرقة الأصولية والسندان الأمريكي، وصار
مطلوب منها الاختيار بين أحد المعسكرين، بينما كان كل ارتكاز وجودها قائم
على تبني ديماغوجية الخطاب الإسلامي داخلياً وتبعية السياسة الأمريكية
خارجياً حتى هؤلاء باتوا محرجين لأن اللعب على الحبال قد انتهى وضاق هامش
المناورة بهؤلاء الذين أصبحوا أكثر هشاشة من أي وقت مضى ، وهكذا، كانت
المغامرة الإسلامية الخرقاء في 11 سبتمبر سبباً مباشراً وأكيداً لاستكمال
هزيمة عام 1967 وإيصالها إلى نهايتها التي طالما تمنتها إسرائيل في إيصال
العرب إلى البؤس واليأس والحضيض الذي لم يعرفوه منذ عصور الانحطاط
والطامة الكبرى هي أن الجماهير العربية الغارقة في الجهل والإحباط
والواقعة تحت تأثير غوغائية الإسلاميين، قد أضحت مغيبة اليصر والبصيرة،
فهي ضمن النفق المسدود باتت غير قادرة على الخروج منه قبل أن تنكفئ هذه
الردة الإسلامية الظلامية التي جلبت الكوارث وشكلت حاجزاً لكل تقدم، وإن
لم يحدث مثل هذا الوعي فالهبوط إلى الهاوية مستمر والآتي أعظم، فغوغائية
الإسلام السياسي تخلط دائماً بين الاستعمار من جهة وبين النظام
الديمقراطي كمنظومة من جهة أخرى وهي ترى بأن الوصفة الديمقراطية لا تصلح
للمجتمعات المسلمة لتناقضها مع الإسلام السياسي من جهة ولأنها الوصفة
التي يروج لها الأعداء .
من جهة أخرى، إن الفكر الإسلامي السياسي الحالي والذي يفكر بعقلية عصور
غابرة، عاجز، في حقيقة الأمر، عن أي تحليل واقعي لما يحصل وهو بالتالي
سجين هذيان وهلوسة، وهو لن ينتشل المجتمعات العربية من مشاكلها وكيف ذلك
وهو أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشاكل ؟. وهو لا يقترح عموماً سوى حلول
مسطحة وشعارات مفرغة من أي محتوى، وآفاق محدودة يلخصها شعاره المسطح ((
لا حل سوى الإسلام )) بينما حقيقة عملهم على الأرض توضح أنه لا أفق لأي
شيء مع الإسلام السياسي إنهم يكتفون بالزعيق والصراخ والتحريض على العنف
والقتل المجاني في كل مكان وهم سيظلون مستمرين في عملهم التهديمي حتى
تصبح البلدان العربية كلها تحت الاستعمار المباشر أو غير المباشر وتغدو
المنطقة متشرذمة، ومتقطعة الأوصال بين المطرقة الأمريكية والسندان
الأصولي، والنتيجة لاستمرار هذه الثنائية هي بقاء المجتمعات العربية
غارقة في الفوضى والإحباط وانسداد الأفق
نأتي على السؤال الأخير ماذا بعد المواجهة و كيف ستحسم هذه المواجهة بين
الأمريكيين والإسلاميين ؟؟
إذا توقعنا نتيجة نهائية لهذه المواجهة بانتصار أحد الفريقين فإننا يجب
أن نتوقع في حال انتصار الإسلاميين – وهو غير ممكن عملياً حلولاً كارثية
من النوع الطالباني في المجتمعات العربية وإن حدث العكس وانتصرت أمريكا
فتلك مصيبة كبرى أيضاً لأن ذلك يعني عودة عصر الاستعمار مع رعايته
الحنونة لطموحات المشروع الصهيوني، وبين هذين النموذجين من المصائب
القادمة، هل من إمكانية أخرى تجنب المجتمعات العربية هذين النوعين من
البلاء : الإسلام السياسي أو الاستعمار الأمريكي ؟؟
مع إدراكنا أيضاً بأن السيطرة الامريكية المطلقة ستكون أسوأ بكثير من
مجمل المشروع الصهيوني وهما في كل الأحوال متطابقان لانهما مرتبطان
رحمياً
إن المجتمعات العربية بحاجة حيوية لاختراع بديل ثالث وبدايته هو القناعة
بأنه لا حل سوى خارج الإسلام السياسي تماماً مثلما هي مقتنعة بأنه لا حل
لمشاكلها بالخضوع للاستعمار الأمريكي .
إن الخروج من هذه الوصاية المزدوجة هو بداية الوعي أما اكتمال هذا الوعي
فهو بالقناعة بأن الديمقراطية هي صالحة لنا حتى ولو كانت تشكل عماد
النظام السياسي لأعدائنا وهي صالحة لنا كما هي صالحة للشعوب الأخرى، وإن
خصوصيتنا الثقافية المزعومة لا يجوز أن تبقينا قابعين في صفوف المعاقين
غير القادرين على تقبل الديمقراطية.
إن البديل الديمقراطي للبلائين المذكورين يبقى في إطار التمنيات الجميلة
والكلام النظري أما واقعياً، فالتنبؤ المستقبلي يجعلنا نتوقع أن الأحداث
ستسلك في المدى المنظور أحد طريقين، أولهما هو أن يحدث للشعوب العربية ما
يحدث للشعوب الحية في المحن، فيصحو لديها الفكر النقدي من غيبوبته، ويصبح
قادراً على تشخيص الواقع الكارثي كما هو بحقيقته، وإن كانت كارثة واقع
الهيمنة الأمريكية واضحة للجميع.
وكذلك كارثة فشل كل الأنظمة العربية بسبب استبداديتها وغوغائيتها تبدو
أيضاً بذات الدرجة من الوضوحأما ما هو غائب عن بصيرة الجميع فهو إفلاس
الإسلام السياسي والكوارث التي تجرها غوغائيته وقصوره وعنفه وتخلفه
.
إن الصحوة لتفهم حقيقة هذا التيار وصولاً إلى انكفائه هو الكفيل بحصول
شيء من التعافي في المرحلة الأولى وهذا التفنيد للإسلام السياسي يجب أن
يترافق مع محاولة الإسلام كدين ومنظومة فكرية تطوير نظرته إلى نفسه وإلى
الآخرين وخصوصاً قبوله لمنظومة الإجماع العالمي على قيم حقوق الإنسان
وحقوق المرأة والحريات العامة والخاصة وعلى رأسها الحريات الدينية
والفكرية، وإن تطوير الإسلام لنفسه ليتماشى مع قيم الحداثة هو من مهمة
المسلمين جميعاً ومسئوليتهم، ومن نتائج هذا العمل هو استكشاف إمكانية
تعايش الإسلام مع مجتمع معاصر حديث يضع تطبيق الديمقراطية هدفاً دون
مماحكات أو مطبات لفظية من نوع الشورى ودون أي شعارات تمويهية وتشويهية
لا طائل من ورائها، فالديمقراطية هي الديمقراطية وهي لا تقبل وصاية أي
شريعة دينية عليها، وهي تعني مجتمع المواطنين وليس مجتمع المؤمنين
.
أما الطريق الثاني فهو استمرار غليان التيارات الإسلامية بمغامراتها
الخرقاء وعنفها اللذان سيدفعان للمزيد من التشرذم والصدام في الداخل
والخارج .
إن المشروع الذي يحمله الإسلام السياسي قد بدأ يؤتي ثماره المرة من
المصائب، إن المصائب الحالية كبيرة ولكن المصائب الآتية على أيدي هؤلاء
أو بسببهم ستكون أعظم وأشد
والتاريخ لن يرحم المغفلين .
|