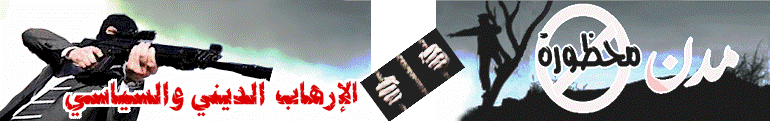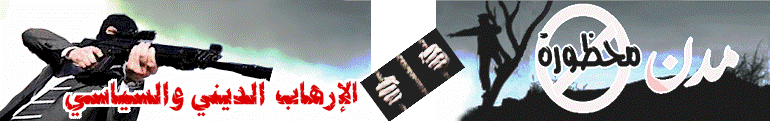|
"الأشياء
التي نتحدث عنها كثيرًا، عادة ما تكون معرفتنا بها أقل " - ديدرو
في نهاية العام الماضي، دعاني الصديق الأستاذ مجدي خليل للمشاركة في
المؤتمر الإفتتاحى لــ “منتدى الشرق الأوسط للحريات” 28-29 نوفمبر
2007.الذي انعقد تحت عنوان ” إلى أين تتجه مصر؟ “، وأجتذب نخبة من ألمع
العقول في مصر والخارج، ومثلت فيه مختلف الاتجاهات الفكرية والإيديولوجية.
وكلفت بعمل ورقة بعنوان ” مستقبل الدولة المدنية في مصر؟ “، تقابل
وتتكامل مع ورقة الصديق الدكتور سيد القمني حول ” مستقبل الدولة الدينية
في مصر؟ “. ولم أكن أدري وقتئذ أن الداهية مجدي خليل من المتنبئين ! وأنه
ربما كان يختبر تصوراته واستقراءاته من خلال أوراق هذا المؤتمر، الذي حفل
بالفعل بالعديد من السيناريوهات الصادمة والتصورات المتشائمة.
لكن يبدو أن الواقع في مصر أسبق من كل خيال، وأسرع من أغلب هذه
السيناريوهات. ففي إشارة خطيرة لتعامل النظام مع الإخوان المسلمين أكد
الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، قبل أيام وفي قلب الولايات
المتحدة، أنه آن الأوان ليكون للإخوان حزب بدلاً من اعتبارهم مستقلين لكي
يبتعدوا عن صفة الجماعة المحظورة. وهو أول رد من قبل النظام الحاكم على
برنامج الإخوان الذي قدموه منذ عام. وهو برنامج يضرب في مقتل فكرة الدولة
المدنية ومفهوم المواطنة، ناهيك عن أن هذا التصريح يفتح الباب أمام جماعة
الإخوان المسلمين للخلط بين الدين والسياسة، علي مستوي الممارسة والتنظير
معا.
ففي الذكري المئوية الثانية لتأسيس الدولة المدنية في مصر بقيادة محمد
علي، اسفرت انتخابات مجلس الشعب عام 2005، التي استخدم فيها الدين جهارا
تحت شعار ” الإسلام هو الحل “، عن نجاح 88 عضوا من جماعة الإخوان
المسلمين، ومن ثم ثار السؤال الصعب عن مصير الدولة المدنية – هذه المرة -
عبر بوابة الديموقراطية.
الأهم من ذلك هو الخلاف حول ” طبيعة ” الدولة، وليس فقط مقوماتها، كما
يقول د. وحيد عبدالمجيد: نظرا لشيوع استخدام مفهوم ” الدولة المدنية ”
دون تعريف محدد له أو لمدلولاته ونطاقه. ولا يوجد تأصيل لما يسمي بالدولة
المدنية إلا التعريف بالسلب فقط، بمعني انها ليست ” الدولة الدينية “،
ونتج عن ذلك نوع من التلفيق وليس التوفيق أو التوافق. لم تكن هناك
بالتأكيد أية مفارقة أو مصادفة، فقد كشف هذا التناقض عن أمور جد خطيرة،
وأهمها عدم وجود التوافق الضروري علي ” مقومات ” الدولة في مصر التي
ينبغي أن تتوافق القوي الوطنية عليها ويلتزم بها الجميع، لأننا لم نحسم
بعد قضية العلاقة بين الدولة والدين، أو بين السياسة والدين، منذ القرن
التاسع عشر.
الدولة المدنية والديموقراطية
يصعب في البداية مناقشة الدولة المدنية بمعزل عن الديموقراطية
الليبرالية، لأنه في غياب الدعائم الليبرالية السياسية يمكن أن تؤدي هذه
الديموقراطية إلى الفاشية، كما يقول أستاذنا الدكتور فؤاد زكريا ، وتصبح
وسيلة لسيطرة التيارات التي لا تؤمن بالديموقراطية من خلال الانتخابات
نفسها، أي ضرب الديمقراطية بسلاح الديمقراطية. فهتلر علي سبيل المثال،
فاز في الانتخابات الألمانية وألغى الديمقراطية عمليا بسلاح الديمقراطية.
والديمقراطية الليبرالية هى ذلك النظام الذى يحترم عملياً ثلاثة مبادئ
أساسية: وهى مبادئ لا يمكن ضمانها إلا فى نظام تمثيلى برلماني. وهذه
المبادئ لا تعود إلى اليونان كما يبدو للوهلة الأولى، وإنما إلى ثلاثة
فلاسفة محدثين هم: جون لوك فيما يخص المبدأ الأول، ثم جون لوك ومونتسيكيو
فيما يخص المبدأ الثانى، ثم جان جاك روسو فيما يخص المبدأ الثالث. ففي
ختام المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني الحاكم (نوفمبر 2007 ) جدد
الرئيس حسني مبارك الحديث عن: ” توطيد دعائم الدولة المدنية الحديثة
وقوامها المواطنة وتعزيز التعددية والعدالة الاجتماعية وعدم خلط الدين
بالسياسة “… وهي المطالب نفسها تقريبا التي ينادي بها العلمانيون. وأعلن
بالمثل المرشد العام الشيخ مهدي عاكف في أكثر من مناسبة: حرص الجماعة علي
الدولة المدنية…. فأين تكمن المشكلة إذن؟
وينص المبدأ الثانى على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية،
والتنفيذية، والقضائية. فالسلطة التشريعية هى التى تصدر أو تبلور
القوانين، والسلطة التنفيذية هى التى تطبقها أو تحولها إلى واقع، والسلطة
القضائية هى التى تعاقب من ينتهكون هذه القوانين حتى ولو كانوا من رجال
السلطة نفسها.
وهذا المبدأ يهدف إلى إقامة دولة الحق والقانون، وهى تختلف عن الدولة
السابقة القائمة على القوة فقط أو البطش والطغيان. أما المبدأ الأول فهو
مبدأ “التسامح”، ويلزم الدولة بأن تضمن على أرضها حرية التعبير عن
المعتقدات السياسية، والفلسفية والدينية، بشرط ألا تؤدى هذه المعتقدات
إلى إشاعة الاضطراب أو الفوضى فى الساحة العامة للمجتمع.
بيد أن تراث الديمقراطية الليبرالية، خاصة فى انجلترا والولايات المتحدة،
أدرك ضرورة وجود أحزاب المعارضة القانونية. ويعنى ذلك أن على حزب
الأغلبية أو الأكثرية واجب التسامح مع حزب الأقلية المهزوم، ومن دون
سياسة “التسامح” يمكن لسلطة الأغلبية فى وقت معين أن تؤدى إلى
الدكتاتورية، وتنتهى فكرة الديمقراطية.
هذا التسامح يعنى، فيما يعنيه، أن القرارات والإجراءات التى تتخذها
الأغلبية، بما فيها سن القوانين، يمكن أن تظل موضع انتقاد الجماهير. وأما
المبدأ الثالث الذى لا يمكن لأى ديمقراطية أن تنهض وتستمر بدونه فهو مبدأ
“العدالة”. فالديمقراطية الحقيقية لا ينبغى أن تكتفى بكونها ديمقراطية
شكلية مفرغة من المساواة والعدل.. فماذا تفعل الحرية إذا كانت الجماهير
جائعة لا تملك قوتها؟.
أضف إلى ذلك أن الإمكانية القانونية فى تشكل أغلبيات جديدة يعنى أنه ليس
للأغلبية فى أى وقت الحق فى أن تفعل كل ما فى وسعها لمنع مثل هذا
التغيير، حتى وإن لم تكن راغبة فيه. فعلى النقيض من ذلك، ينبغى للأغلبية
الحاكمة أن تقبل هذه الإمكانية على أنها مسألة مبدئية. وأن يسمح قانونياً
بتغيير الحكومة ويكون التغيير ممكناً فى الواقع. والشروط اللازمة لهذه
“المسئولية الحقيقية” هى حرية الإعلام والنشر مع حرية التنظيم والتظاهر.
هكذا نجد أن الديمقراطية الليبرالية تفرز التسامح وترعاه أيضاً، وأن
التسامح بدوره يحافظ على الديمقراطية من أن تتحول إلى نقيضها
(الدكتاتورية) وخطرها المتمثل فى الشمولية والعنف. ذلك أن أية محاولة
لإعطاء قرارات الأغلبية صفة (الإطلاق) تعنى انكار طبيعتها المشروطة، فيظل
للأقلية الحق من خلال وسائل الإعلام فى أن تطالب بتعديل القرارات التى تم
إصدارها فى فترة انتخابية أخرى.
إذن السبيل إلى الدولة المدنية هي الديمقراطية الليبرالية والمؤسسات
الدستورية والقضائية المستقلة وحقوق الأفراد وحقوق الأقليات وحرية
العقائد ، كما يقول الدكتور خالد يونس خالد في بحثه القيم : الديموقراطية
الليبرالية والدولة المدنية الدستورية : الذي قدم في مؤتمر دعم
الديموقراطية في لندن ، ونشر موجزه في ” دروب ” علي حلقتين ( 2 أكتوبر
و17 توفمبر 2007 ) وأستفدنا منه كثيرا
.
مهمة الدولة المدنية، كما حددها جون لوك، هي المحافظة على كل أعضاء
المجتمع بغض النظر عن الدين أوالجنس أوالفكر. فهي تضمن حقوق وحريات جميع
المواطنين باعتبارها دولةَ مواطنة، تقوم على قاعدة ديمقراطية هي المساواة
بين المواطنين فى الحقوق والواجبات. وعليه فالمواطنون لهم حقوق يتمتعون
بها، مقابل واجباتٍ يؤدونها. وهذه المواطنة لصيقةٌ كليا بالدولة المدنية،
فلا دولة مدنية بدون مواطنة، ولا مواطنة بدون دولة مدنية. وعليه
فالمواطنة لا تتحقق إلا في دولة مدنية ديمقراطية تعددية دستورية تصون
كرامة المواطن وقناعاته في ممارسة معتقداته وأفكاره بالشكل الذي يؤمن بها
في إطار الدستور الذي أقره الشعب.
والمواطنة حسب «مونتسكيو» في كتابه «روح القوانين» أو الشرائع، هي
الفضيلة السياسية في الدولة المدنية.
ذلك ان مفهوم الوطن يقترن عنده بمفهوم المساواة، المساواة في الحقوق،
والمساواة أمام القانون، أو قل «المساواة السياسية»، ولذلك كان حب الوطن
أو حب المساواة فضيلة سياسية. أي أن المساواة السياسية بهذا المعنى مقدمة
لازمة وشرط ضروري للمساواة الاجتماعية.
لقد جعل «الوطنية» صفة للدولة وتحديد ذاتي لمواطنيها، وهي على الصعيد
القانوني ترادف «الجنسية»، وحسب «حنا أرندت» فإن الجنسية هي «الحق في أن
يكون لك حقوق» إذ أن جميع من يحملون جنسية دولة معينة هم مواطنوها، بغض
النظر عن انتماءاتهم الأثنية أو اللغوية أو الثقافية أو الدينية، وبصرف
النظر عن اتجاهاتهم وميولهم الفكرية والأيديولوجية والسياسية.
ويمكن القول أن الوطنية هي التحديد الأخير لمواطن دولة ما، وهو تحديد لا
ينفي أو يلغي عن هذا المواطن انتماءه الأثني أو اللغوي أو الديني … ولكنه
ينفي أن يكون هذا الانتماء « ما قبل الوطني » هو ما يحدد علاقته بالدولة،
ويعين من ثم حقوقه التي هي واجبات الدولة، وواجباته بما هي حقوق الدولة
وحقوق المجتمع. معني ذلك أن الديموقراطية الليبرالية تستند إلي دستور
مدني يحقق المواطنة، لأن حكم الاغلبية لا يعني حرمان الأقلية في صنع
القرار. ومن ثم فالديموقراطية التي تحكمها الأغلبية ولا تقوم على أساس
ليبرالي تعرقل تحرر الأفراد والمجتمعات وتضيع حقوق الأقليات.
العلمانية تفصل السياسة عن الدين ولا تتناقض مع الدين وحق المواطنين في
ممارسة عقائدهم بمنتهى الحرية ، حسب د. خالد ، بينما تكَفر الدولة
الدينية فصل السياسة عن الدين، والتكفير سلاح قوي لإدانة كل مواطن يعارض
النظام، لأن المعارضة في الدولة الدينية ممنوعة باعتبارها مخالفة لشرع
الله، على حد زعمهم. في حين أن المعارضة واجبة وضرورية في الدولة
العلمانية الديمقراطية الليبرالية الدستورية التي تؤمن بالتعددية كحالة
صحية.
أضف إلي ذلك أن الدولة الدينية ” ترفض الديموقراطية لأن الشعب ليس مصدر
السلطات وإنما الشرع الديني، وبذلك ليس للشعب دور في الحكم. ولا يمكن
بناء الدولة المدنية في ظل الدولة الدينية، لأن العقيدة، أية عقيدة كانت،
لا تؤمن بحق جميع المواطنين على قدم المساواة طالما أن القانون الديني
يميز بين العقائد. ومن هنا تبرز أهمية حرية العقيدة في الدولة المدنية،
التي هي علمانية بالضرورة، حيث تسمح بممارسة المواطنين لعقائدهم بحرية
وبدون تمييز وبنفس الشروط علي أساس حق الجميع في المواطنة بالتساوي.
فأي رجل دين يستطيع ان يكفر الرأي المعارض والمختلف معه، لأن السلطة التي
يستمدها رجل الدين في مجتمعنا، الذي لم يتعلمن بعد ” فوق الحرية ” أو قل
ان هذه السلطة هي التي تحدد ” مساحة الحرية ” وضوابطها، وهذا يتماشي
تماما مع المساحة ذاتها التي تريدها السلطة السياسية. ومن هنا نجد أن
الدولة الدينية تتمتع بالسطوة الدينية والسياسية بربط الدين بالسياسة،
وجعلْ الدستور سلاحا لضرب الشعب بينما الدولة الديمقراطية العلمانية
الليبرالية الدستورية تجعل االشعب صانع الدستور ليحميه من الظلم، ويحمي
حقوقه وواجباته” .
كيف يتم الألتفاف حول الدولة المدنية؟
في إحدي لمحاته الذكية لاحظ د. عبدالمنعم سعيد أن الإسلام السياسي يطرح ”
دولة دينية ” ذات غطاء مدني، بينما تقول جماعة الإخوان المسلمين بدولة ”
مدنية ” وليست ” دينية “. ومفهوم الدولة المدنية عندهم هو: الدولة التي
لا يحكمها رجال دين، أما ان يحكم ” الدين ” الدولة، باسم تطبيق الشريعة
فتلك مسألة أخري.
وبالتأكيد، فإن الدين لا يحكم وإنما البشر هم الذين يحكمون، وعندما يحكم
هؤلاء باسم الدين، فإنهم يكونون رجال دين حتي ولو لم يلبسوا العمامة مرة
واحدة.
وبنفس الطريقة من الالتفاف تجدهم يقولون بالمواطنة كأساس للدولة المدنية
المزعومة. بيد انها لا تعني عندهم ما تعنية في الدولة المدنية الليبرالية
العلمانية الدستورية (الديموقراطية)، وإنما تعني ان العلاقة مع الغير –
الأقباط مثلا – تقوم علي مبدأ ” لهم ما لنا وعليهم ما علينا “، وهو ما
يعني انهم وحدهم يقررون أولا ثم بعد ذلك يعممون ما يرونه علي أساس قاعدة
المساواة القائلة ” المساواة في الظلم عدل “، وبالطبع فأن قاعدة المساواة
سوف تعطى الأقباط والمرأة مساواة كاملة فى تولى كافة المناصب العامة ما
عدا أمرا واحدا هو “الولاية العظمى”.
والخلاصة: ضياع مستقبل الدولة المدنية في مصر بين استغلال الدين في العمل
السياسي، للوصول إلي الحكم، مثلما هو الحال مع جماعة الإخوان المسلمين
وغيرها.. وبين استغلال النظام السياسي، للدين لترسيخ السلطة حتي ولو كانت
منفردة، وتحقيقا لأهداف سياسية وحزبية لم تستطع تحقيقها بالوسائل المدنية.
أضف إلي ذلك، دعاه “المواءمة السياسية” (بين النظام والإخوان) الذين يرون
أن ” توقيت ” المطلب غير مناسب بالنسبة لتعديل المادة الثانية من
الدستور، رغم أنها لم تكن مطروحة أصلا للتعديل ضمن باقة ال 34 مادة، ومن
ثم لم يحسم التساؤل الجذري والمحوري حول طبيعة الدولة المصرية في مطلع
القرن الحادي والعشرين. الغريب في الأمر ان برنامج جماعة الاخوان
المسلمين الأخير الذي جاء في 128 صفحة، يلغي كل المفاهيم المتعلقة
بالدولة المدنية المزعومة ويقيم مكانها دولة ” دينية ” صريحة.
وفي كل الأحوال تنتعش المؤسسة الدينية في مصر، وتلعب أدواراً مركبة
ومتعددة في الحياة العامة، وتتدخل بدرجات متفاوتة في العمل السياسي
العام، وتدلي بدلوها، عبر الفتاوى والعظات العامة في أمور مدنية بحتة!
فبعد قرنين كاملين من محاولة إنشاء دولة مدنية حديثة، ما زلنا حائرين في
ماهية تلك الدولة وهل هي حقا مدنية، أم دينية. وحين يتوه الجميع في دوامة
خلط المفاهيم يصبح المخرج الوحيد هو: “دولة مدنية ذات مرجعية دينية”، أو
دولة دينية ذات غلاف مدني.
|